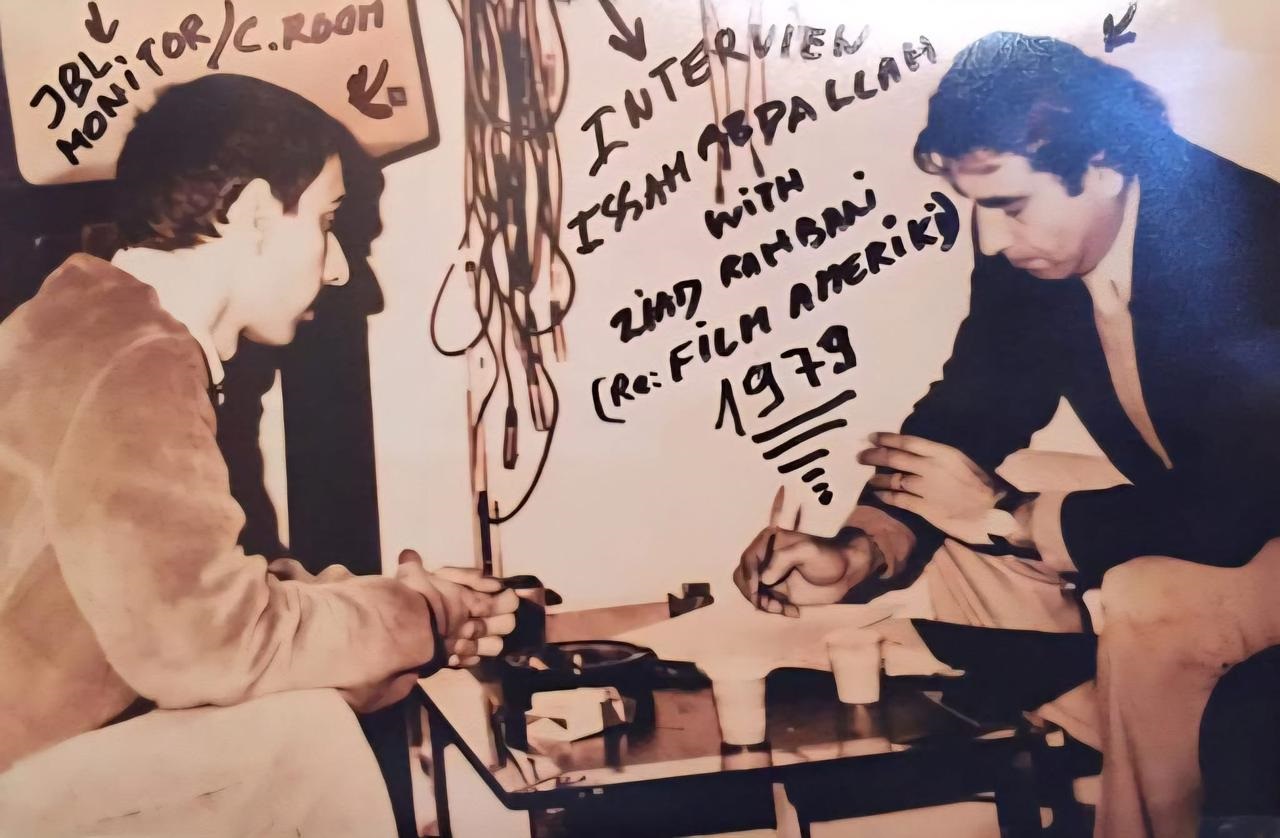الخاتمة
“مش عارف شو بينعمل… أنا ما بآمن إنّه بتكتبي شي بعد ما الإنسان يموت، بس ما في شي تاني، ما عنا شي تاني، في شي لازم ينقال عن هالزّلمة” – زياد الرحباني، متكلّما عن الشاعر أنسي الحاج1
لماذا نكتب عن زياد الرحباني؟ يُمكن، كما قال “في شي لازم ينقال عن هالزّلمة”، ويُمكن أيضا، بناءً على ما قال جوزيف حرب في العام 1993، زياد الرحباني يلتقي مع كل إنسان جاء إلى هذه الأرض. أول ما يجيء لي عن الإلتقاء هذا هو التماس اللغوي، هذا التقارب اللاسع بين فكرة مبهمة في الرأس لم تجد طريقها بعد، وبين كلمات متراصّة تختم المعنى. صعبٌ ختم المعنى، حيث تكتفي اللغة بنفسها، فيصير شبه مستحيل حذف كلمة أو إضافة أخرى.
تكثّفت علاقة زياد مع اللغة عبر السنين، أكان عبر اعترافاته في عدّة حوارات عن علاقته باللغة العربية في مدرسة الجمهور، وصعوبة التعبير بهذه اللغة نظرًا للكولونيالية الطاغية في المدرسة، أم في محاولاته التعبيرية بالعربية كشاعرٍ صغير خارج المدرسة، عبر محاولات نصية نثرية في كتابه “صديقي الله”، أو تنحّيه عن الشعر كشاعر وعمله مع شعراء آخرين كموسيقيّ، كمرافق لشعر الآخرين. في تلك الرحلة تومض آثار شعرية لزياد الرحباني، بالرغم من عدم تحبيذه الشعر. أولى هذه الومضات هول العربية نفسها كلغة أساس. ففي حوار له مع الشاعر عباس بيضون عام 1996 ركّز زياد الرحباني على أهمية اللغة العربية، من دون الحديث عن اللغة بطريقة مباشرة، تكلّم عن عذابه اليومي في مدرسة الجمهور، هذا الإغتراب الشديد في التواصل والسياسة الذي شعر به في المدرسة وهذا العذاب وسط لفظ حرف “الراء” بالطريقة الفرنسية (أي “غاء” والتي عن قرارٍ رفض لفظها هكذا). ذكر زياد أيضًا أن كان له صديقًا وحيدًا في المدرسة، ثاني متكلمي اللغة العربية بعده. أي، ربط زياد صداقته الوحيدة لا بالشخص أولًا، بل باللغة الرابطة مع هذا الشخص، أي بالتواصل باللغة العربية. وتأطّرت هذه العلاقة مع اللغة بالموقف السياسي الذي أعاد زياد ذكره في مقابلات عدّة: “الغرب هوي مستعمرنا ثقافيًا، وهاي الكلمة ما في غيرها، مش انه راحت أو هاي لغة خشبية”. أكّد زياد على مصطلح “الاستعمار الثقافي”، قال بوضوح أنها الكلمة الوحيدة التي تصف الواقع السياسي والثقافي، وقابلها بمصطلح “لغة خشبية”. ركّز على اللغة، وهو يعرف بدقّة أن استبدال المصطلحات اللغوية تعني تغيير المعنى، وبالتالي الموقف، وبالتالي الواقع. حارب الاستعمار بالموقف السياسي أكيد، ولكن باللغة أيضًا. انطلاقًا من غرقنا الأول في اللغة، أي منذ الخلق، كتب الصديق زكي محفوض في رحلة، وبالتحديد، في عدد “الولادة” (آذار 2021) التالي: “أثناء عملية الولادة، يتكفّل الرحم بقذف الجنين إلى الدنيا… والإنسان لا يحضر إلى الدنيا بملء خاطره بل “انقذافًا””. لكن الانقذاف الحقيقي والأقرب إلى الواقع هو الانقذاف داخل اللغة، الوعاء الثاني، بعد الخروج من الوعاء الأول، أي رحم الأم. أخذت اللغة عند زياد أشكالًا عدة، وتمحورت حول معانٍ عدة، وعندما تكلّم عن المدرسة الفلسفية الواقعية، أو كما ترجمها هو في إحدى مقابلاته “naturalisme”، حكى عن كونه ناقلًا لهذا الواقع، وسيطًا، ينقل لغة الناس و تعابيرها اليومية جدًا. يسأله عباس بيضون محاورًا “لغة الشعب فتنتك أيضاً؟”، يجاوب زياد: “أنا أستعير الكثير من لغة الناس، وأغرف من قاموس الحياة اليومية. ثم يذهب الناس إلى المسرح ليسمعوا ما أخذتُه منهم، ويضحكون كما لو كنت أنا مؤلفها ولا يدرون أنه كلامهم! لو أستطيع لحملت جهاز تسجيل طوال النهار، ودرت به طول النهار لأسجّل كلام الناس. فالذاكرة لا تكفي. هناك طبعاً من يرى أنه ليس مسرح ابتكار، بل غارق في الـ”Naturalisme”، يعني واقعية.” لكن جواب زياد يروح أبعد من لغة “الشعب” إلى عمق اللغة نفسها بالمعنى الفلسفي، كون اللغة هي الواقع الأول، والمكّون الأول لأعماله.
في البحث عن هذه الآثار اللغوية يبرز كتاب “صديقي الله” كمحاولة شعرية تنتقي كلماتها العربية بدقّة. صدر الكتاب في 31 آب عام 1971، حين كان زياد في عمر الـ15. يحضر الاهتمام اللغوي في كتابه الذي تألف من 49 نصًّا. يقول زياد في النص رقم 14 “لا أريد أن أصلي إلا ما افهمه”، أي أن الفهم شرط الصلاة والوصل، أي أن لغة الصلاة من كلام وصوت ومعانٍ تشكّل شرطَ الإيمان. اللغة العربية، إذن، تشكّل أساسًا لفهم العالم والغيب.
يتكلم زياد عن هذا الكتاب ببعض من الخجل، والكثير من عدم التقدير أو اللامبالاة، “ما بعرف شو شاف لَ طبع منه 500 نسخة”، يتساءل زياد عن الأسباب التي دفعت بوالده عاصي إلى طبع الكتاب وتوزيعه على الأصدقاء. يسمّيه “الديوان المسرّب”، كونه طُبع من دون إذنه. أيقظ هذا التسريب في زياد، عن عمرٍ صغير، مفهوم العام والخاص. وأيقظ فيه الخجل لدرجة مكوثه في المنزل، وتفاديه الذهاب إلى المدرسة. ولحسن حظّه لم يقرأ أحدًا من التلاميذ هذا الكتاب، كونهم لا يتكلمون العربية في مدرسة الجمهور.
أول انطباع عند قراءة “صديقي الله” أن هناك نبيًّا صغيرًا في كل شاعر. لا أدري أين قرأتُ هذه الجملة، أم إنها جاءت إلى مخيّلتي من دون تفكير. تأتي أحيانا الكلمات كصورة، كلحن، كمرسال. فالشعر فيه شيء من النبوءة، والشاعر فيه الكثير من الغيب، والغيب لا وقت فيه. قديم كتاب زياد الرحباني “صديقي الله”، لكن فيه من الغيب، أي يقفز فوق الوقت، ومن فرط حساسية الشاعر تكاد لغته ان تكون الوقت نفسه. هناك أعمال إبداعية، تتخطى الوقت فتغرز نفسها كنقطة ثابتة في الخواء. لماذا نحبّ المبدعين؟ لأنهم يحملون الخلق كنبوّة تحفر وتغرس. يعترف زياد أنه لا “يطيق” هذا الكتاب، ولكن، لا يلغي كره الكاتب للكتاب أهميّته، ولا يُقاس الإبداع بميزان المؤلّف. فالرسام فان غوخ كره لوحته الشهيرة “ليلة النجوم”، وذكر في إحدى رسائله أنها لوحة فاشلة، والأمثلة تتكاثر.
يفتتح زياد كتابه “صديقي الله” بالشكّ الكبير، بالسؤال الوجودي – “ماذا أعرف، لا أعرف شيئًا ” 2؟ يذكرنا بطلاسم إيليا أبي ماضي3.
لا نعرف إن أُعيدَ ترتيب النصوص في الكتاب، وإن كان فعلًا هذا الشك الكبير مدخلَ “صديقي الله”، لكن تسلسل هذه النصوص يشكّل خطّا دقيقًا: افتتاحية تبشّر بالشكّ العظيم، البحث عن الله (عبر صداقة لا تُرى بل تُحسّ كما وصفها)، الوحدة مع الطبيعة والذوبان في الوقت، تراجع وجود الله في الكتاب مع تزايد حضور الأب والأم، مجيء الحرب والخوف الكبير وأخيرًا الاصطدام بالواقع. ولكن في الكتاب كاملًا يلعب الكاتب دور الشاعر المراقِب، إن كان الطفل الذي يراقب أفكاره الوجدانية، أو الكروم والطبيعة، أو أهله، أو الحرب. يحسّ القارئ بقوة التصادم مع الواقع، فبعد نصوصٍ تأخذنا إلى الرومنطيقية المفرطة، من التوحد مع الطبيعة، والعيش خارج الوقت، والجوّ العام الشبيه بالحلم، تأتي الحقيقة. يعود الكاتب إلى سؤاله الكبير حول المعرفة، قائلا ان الانسان متى عرف الحقائق سقط عن سرير الأحلام. يكتشف الكاتب الفُراق وينتقل إلى واقع سوداوي، فيقول “كم من شيء أريد منه أن أتدارى لكن لا مفرّ من الدموع”. وكأن الكاتب يُعلن حقيقة هذا الوجود.
كره زياد هذا الكتاب اللطيف، واعترف مرة انّه لا يحبّ الشعر كثيرًا. ولعلّنا شهدنا أجمل مقابلاته عندما حاوره الشعراء والكتاب. وكأن وجود الشعر واللغة حوله أرض خصبة لإبراز الشاعر الذي فيه. أحبّ زياد أنسي الحاج، ومارسيل بانيول، وموليير، وكره جان راسين، كما قال إنه شعر أن موليير “قريب، كما لو كان واحدًا من عكّار”. أحبّ زياد أيضا الشاعر عصام العبدالله، وقال يومًا في حوار إذاعي، متوجّها إلى المحاوِرة: “بدي قلّك شغلة، أحلى شغلة باقية براسي قايلها عصام العبدالله، الله يطوّل بعمره، “بيروت عنقود الضِيع”، فظيعة شو هالاختصار الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لَ شو هيي بيروت”4. في العام 1982، وضع زياد موسيقى مرافقة لِـ “قهوة مرة”، أول ديوان للشاعر عصام العبدالله. ولعلّ هذا الشكل من الإخراج الشعري كان الأول في العالم العربي. حيث جرى تصوير الشاعر عصام العبدالله يلقي الشعر مع موسيقى خلفية من تأليف زياد الرحباني. رافق عصام العبدالله زياد في العمل الإذاعي، وشارك بكتابة بعضٍ من نصوص “بعدنا طيبين قول الله”. كتب زياد الطفل ديوانًا شعريًا، كبر وقال إنه لا يحبّذ الشعر كثيرًا. كبر ولحّن للشعر المحكيّ، وكأنه مسك الشعر من خضمّ ذاته، موسيقةً ولغةً.
في أولى مقابلاته مع مجلّة الشبكة، عام 1971، في نفس السنة التي نُشر كتاب صديقي الله، سُئل زياد التالي:
– هل تعتقد أن مَلَكة الشعر وراثية؟
– الشعر لا يتوارث، وابن الشاعر ليس بالضرورة شاعرًا.
اعترف زياد الصغير بأنه كان شاعرًا، وفي جوابه هذا، يشعر القارئ برفضٍ لشاعريّة آبائه، أو اعتراف بميزته الشعرية، الغريبة عن جو العائلة. من ثمّ كبر زياد واعترف بأنه لا يحبّذ الشعر وبين الاعترافين حقيقة شعرية غير قابلة للطمس. مات زياد فانهمر الشعر وراءه على الأرصفة والطرقات من شارع الحمرا إلى بكفيا. كان الشعر في الجوّ كثيفًا، لا يُرى ولكن يُحسّ كخاتمةٍ أزلية. كان لا بدّ من خاتمة ما لحفلة الموت الكُبرى. خاتمة تفرّغ المعنى من اللغة وتفرّغ اللغة من ذاتها وتُفرّغ لبنان من نفسه. نحن الذين وُجدنا على تماسٍ متواصل مع الوجود واشتباك مستمرّ مع مرارة هذا الشرق الأوسط الحزين. مشينا وراء كبدٍ منهك لأننا رفضنا المشي وراء التزيّف. مشينا، علّنا نجد في آخر مطاف هذا الطريق سماءً ولغة تحتوينا. منذ حين، نشعر أن للتاريخ طعم ورائحة، أننا عالقون في التاريخ، يصنعنا ونصنعه، يحاكينا ونناجيه، لحظة انكشاف مع الذات. للتاريخ طعم ورائحة وشواهد، فعُقب لحظة تُعادِل تاريخًا بأكمله. عُقب لحظة تنسج تاريخًا بأكمله.
كان البحر يتغيّر، يميل إلى حزنِ عظيم يتسع للبوارج الحربية والحصار، من غزة، إلى الناقورة، إلى بيروت. وكانت اللغة تتهاوى، وما زالت، ومع موت زياد الرحباني لفّ الشعر المدينة الفارغة. كبر زياد ومات وعاش شعره، أكان الشعر الكامن في رفضه لفظة “غاء” الفرنسية، انغماسه باللغة العربية، أو في كتابه “صديقي اللـه”، أو في مجمل شاعريته على البيانو أو في ماركسيّته الراديكالية. لماذا نكتب عن زياد الرحباني؟ يُمكن، كما قال يومًا عن أحد الشعراء: “أنا ما بآمن انه بتكتبي شي بعد ما الإنسان يموت. في شي لازم ينقال عن هالزلمة”.
- من حوار له مع الشاعرة لوركا سبيتي، إذاعة صوت الشعب، السبت 29 آذار 2014 ↩︎
- “أنا صغير ولسادس مرة أطفئ الشموع ما أحلى الحياة عند اطفاءة شموع سادسة.. ما أعرف ؟ لا أعرف شيئا.” _ كتاب صديقي الله، زياد الرحباني، نصّ رقم 1، 1971 ↩︎
- “جئت، لا أعلم من أين، ولكنّي أتيت
ولقد أبصرت قدّامي طريقا فمشيت
وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟
لست أدري!” _ ديوان الجداول، إيليا أبي ماضي، الطلاسم، 1927 ↩︎ - من حوار له مع الشاعرة لوركا سبيتي، إذاعة صوت الشعب، السبت 29 آذار 2014 ↩︎